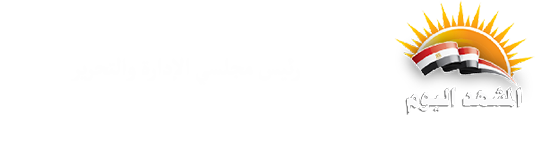رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن معجزة الأخلاق النبوية الشريفة
بقلم \ المفكر العربى الدكتورخالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
مما لا شك فيه أنه لا يمكن لنا حين نتصدَّى للتعريف بشخصية خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم؛ إلا أنْ نقرَّ ونذعن بأننا نتحدث عن أحسن الناس وأشرفهم وأكرمهم وأعظمهم وأكملهم في صفاته وأخلاقه وسيرته وأثره في الدنيا، في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام.
إننا نتحدث عن إنسان وقف التاريخ معه، يرصد خطواته ويسجل أقواله، ويرى فيه منقذ البشرية مِن لوثاتها وأمراضها التي استعصت على الأطباء، ثم هو يسير معه سير التلميذ مع أستاذه، يتعلَّم منه، وينقل أقواله وأفعاله للآخرين، فيجد فيها الجميع راحتهم وخلاصهم، وتسكن إليها نفوسهم، فيؤمن بها مَن أراد لله له الخير والهداية والرشاد والنجاة، ويجحدها ويحقد عليها أصحاب القلوب القاسية، ممن طمس الله على عقولهم وأبصارهم، فلا يَرَوْن الحق ولا يعرفونه.
والذي ينظر إلى حالته عليه الصلاة والسلام، وكيف قاد قطار الأمة بين الصعاب، وبدأها بنفسه وأكمل بنيانها حتى بدأت ترسل الوفود والرسائل للممالك الكبيرة تدعوها للإسلام، وتتصدّى لدعوتهم وهدايتهم لما فيه خيرهم ونفعهم، ثم تموت أممٌ وتبقى هي تطرد الرديء عن نفسها وتكمل المسيرة بخيرة أبنائها، تلك الأمة التي بناها عليه السلام من لا شيء وأوصلها إلى كل شيء، نعم أوصلها إلى كل شيءٍ، وكانت كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران:110].
فمَن فعلَ هذا غيره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟
وفي الوقت نفسه يقوم بتعليم أمته أمور دينها، فلا يترك كبيرًا ولا صغيرًا إلا دلَّ أمته عليه، وعلّمها إياه، حتى أدب دخول الحمام، وإزالة الأذى عن الطريق، والشوكة تصيب المؤمن.
وفي الوقت نفسه يقوم بحقوق زوجاته، فيكون خير الناس لأهله، وربما قام بإصلاح ثوبه بنفسه، ويتفقد أصحابه ويمشي في قضاء حوائجهم وديونهم وزواجهم وغير ذلك.
وهو أيضًا يستقبل الوفود والقبائل التي تريد الدخول في الإسلام، ويأتي الأعرابيُّ فيجذب ثوبه فيصبر عليه، ويبول الرجل في المسجد فيصبر عليه ويُعلِّم أصحابه الرفق به وكيف يطهِّرون المكان، وتأتي المرأة فتوقفه فيذهب ويقضي لها حاجتها.
وأمورٌ كثيرةٌ كثيرة، يعرفها كلُّ مَن طالع سيرته صلى الله عليه وسلم، بحيثُ لو قام ببعضها على وجه الكمال لكان مفخرة لأتباعه، فكيف بقيامه بها كلها على أكمل وجهٍ وأحسنه؟
فكيف تسنَّى له القيام بكل هذا، وهو يمرض كما يمرض الرجلان مِن أُمته؟ ويتزوج بأكثر من واحدة، ومطلوبٌ منه أن يقوم بأعباء النبوة والرسالة، والدولة الناشئة، والدفاع عنها، وإقامة العدل ونشره في الخلق، ودعوة الخلق إلى الحق، وقضاء حوائج أصحابه، والقيام بأعباء بيته الشريف، إلخ إلخ.
فمتى وكيف أوجد الوقت لذلك كله؟ وكيف قدر عليه؟ بل كيف بلغ في ذلك كله حدَّ الكمال؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
ومهما حاولنا الجواب عن هذه الأسئلة أو غيرها فلن نجد جوابًا أحسن وأدق مِن الإذعان بنبوّته واصطفاء الله عز وجل له، وإعانته وتوفيقه على ما كلَّفه به، وأنَّ الأمر اصطفاء رباني، وأننا أمام أعظم إنسان.
أعظم إنسان في تواضعه وشجاعته وخُلُقِه، كما قال سبحانه عنه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:4].
فهو الكريم كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقَّة:40].
وإن سألت عن أخلاقه “كان خُلُقه القرآن”، “أحسن الناس خُلُقًا”.
وفي كرمه “أجود بالخير مِن الرّيح المُرسَلة”.
وفي شجاعته كان أصحابه يحتمون به إذا اشتدت الحروب.
وكانت بعثته عليه السلام رحمة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:107].
رحمة بأمته، التي خرجت من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومِن ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم.
ورحمة بالمرأة، التي أعطاها حقوقها، وحفظ مالها وميراثها، وهي التي كانت تُدفن حيّة عند ودلاتها في الجاهلية، وتختلف فيها أوروبا يومًا ما: هل للمرأة روح أم لا؟
ورحمة بالنصارى الذين ألهبتهم سياط يهود ومزاعمهم في نبي الله عيسى وأُمِّه عليهما السلام، واتهامها بالفاحشة وهي البريئة الصّدِّيقة البتول، فوثَّق معجزتها الخالدة، وسُمِّيت سورة في القرآن باسمها.
بل رحمة بالجن الذي استمع للقرآن الكريم، فآمن وأسلم لله رب العالمين.
ورحمة بالحيوان، فلا يجوز في ديننا اتخاذ حيوان غرضًا، أو تعذيبه، أو تحميله فوق طاقته.
ورحمة بأعدائنا الذين حاربونا فغدروا وخانوا ودَمَّروا، لكنَّا لا نغدر ولا نخون، ولا يقطع جنودنا شجرة، ولا يقتلون شيخًا عجوزًا أو طفلا أو امرأة مسالمة[1].
فقد بنى أعظم إنسان عليه السلام أُمّةً يرميها الناس بالطوب فترميهم بالثمر.
ونحن عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن بالفعل نتكلم عن أعظم إنسان عرفته البشرية، في تاريخها السابق واللاحق، فهو مثال فريد لم يتكرر.
والبشرية تعرف رجالا اشتهروا بصفة أخلاقية كشجاعة عنترة، وكرم حاتم، لكن لا تعرف غير النبي عليه السلام جمع بين كل هذه الصفات، وبلغ الكمال فيها، فقد جمع أحسن الأخلاق وبلغ الكمال فيها جميعًا، وهذه لمن تدبّر إحدى دلائل نبوّته.
ومِن ثَمَّ ذهب القفال والماوردي وغيرهما إلى عَدِّ أخلاقه العظيمة مِن أمارات نبوّته عليه السلام.
فيقول الإمام القفال في “الشمائل النبوية”: “إن أحد ما يؤكد الاستدلال به على صحة نبوة الأنبياء اعتدال شمائلهم، وطهارة أخلاقهم، ودوام جريهم في سِيَرهم ومذاهبهم في أسباب الدين والدنيا على طريقة محمودة تدُلُّ ذواتُهم عليها، على أنهم أُمِدُّوا في ذلك بقوة سماويَّة؛ لخروجهم – فيما يُشاهدُون عليه من لزوم هذه الطريقة – عما جُبل عليه البشرُ من تلوُّن الأخلاق، ودُخُول ما يمتدُّ استعمالهم للمحمود منها في باب التكلف الذي لا يكاد يدوم، ولا يَعرى صاحبُه والآخذ نفسه به من تغيُّر يلحقه”[2].
ويقول الماوردي في “أعلام النبوة”: “الباب العشرون: في شرف أخلاقه وكمال فضائله صلى الله عليه وسلم: المهيَّأ لأشرف الأخلاق وأجمل الأفعال، المؤهل لأعلى المنازل وأفضل الأعمال؛ لأنها أصولٌ تقود إلى ما ناسبها ووافقها، وتنفرد مما باينها وخالفها، ولا منزلة في العالم أعلى مِن النبوة التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده، تبعث على مصالح الخلق وطاعة الخالق، فكان أفضل الخلق بها أخص، وأكملهم بشروطها أحق بها وأمسّ، ولم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وما دانى طرفيه مَن قاربه في فضله، ولا داناه في كماله خَلْقًا وخُلُقًا وقولًا وفعلًا، وبذلك وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾. فإِنْ قيل: فليست فضائله دليلًا على نبوّته ولم يُسمع بنبيٍّ احتجَّ بها على أُمته ولا عوّل عليها في قبول رسالته؛ لأنه قد يُشارَك فيها؛ حتى يأتي بمُعْجِزٍ يخرق العادة، فيُعْلَم بالمُعْجِز أنه نبي لا بالفضل؟ قيل: الفضل مِن أماراتها وإِنْ لم يكن مِن معجزاتها، ولأنَّ تكامُل الفضل مُعوز فصار كالمُعجز، ولأنّ مِن كمال الفضل اجتناب الكذب وليس مَن كذب في ادّعاء النبوة بكامل الفضل، فصار الفضل موجبًا للصِّدق، والصدق موجبًا لقبول القول، فجاز أنْ يكون مِن دلائل الرُّسُل”أهـ[3].
وتتضح هذه القضية من خلال دراسة الواقع العربي عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
حيث جرى تزييف تاريخ العرب وتقديمهم بالصورة الهمجية القائمة على الفوضى والنهب والسلب وقطع الطريق، ولا ننكر أبدًا وقوع العرب في آثام وطوام كبيرة من الشرك بالله وعبادة الأصنام فضلًا عن الموبقات الأخرى المشار إليها، وإنما ننكر سلبهم وتجريدهم من كل فضيلة، فلم يكن العرب كذلك، وإنما كان العرب كغيرهم من الأمم لهم وعليهم.
وعلى الرغم من وقوعهم في طوام الشرك والآثام إلا أننا نلحظ وبسهولة تلك النزعة العربية جهة الأخلاق الحميدة، وحب أهل الخير والأخلاق.
وعلى خلاف أمم الأرض الأخرى لم يجحد العرب وجود الله عز وجل، ولم ينكر العرب قدرته على الفِعْل، وإنما ضلوا السبيل في طريقة الوصول إليه، فاتخذوا أصنامهم وأوثانهم شركاء يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زُلْفى.
وقد دلَّ القرآن الكريم على ذلك في قوله سبحانه: ﴿ أَلَا للهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزُّمر:3].
فلم ينكر العرب وجود الله عز وجل، بل اعترفوا بوجوده، وآمنوا به ربًّا، ثم أشركوا معه غيره، واتخذوا بينه وبينهم واسطة تقربهم إليه بزعمهم.
وهذه المرحلة التي وقف فيها العرب رغم شناعتها مِن جهة صحيح العقيدة؛ غير أنها مرحلة متقدمة على مراحل الأمم الأخرى التي جحدتْ وجود الله عز وجل، وعبدت النار، أو البهائم، أو الطبيعة، أو تمادت فأنكرت وجود آلهة في هذا الكون مطلقًا.
فهذه المقارنة بين العرب المعترفين بالله ربًّا، المشركين به في إلهيته، المتخذين واسطة بينه وبينهم، وبين الأمم الأخرى الجاحدة لوجود الله عز وجل أصلًا، هذه المقارنة تميل إلى صالح العرب قطعًا، وتجعلهم أمة أكثر تقدُّمًا وتحضُّرًا عن تلك الأمم الأخرى الأشد تخلُّفًا وتماديا في حماقة الإلحاد والكفر والجحود.
فالذي يعترف بوجود الله عز وجل ثم يتخذ له واسطة تقرّبه إليه، أفضل عند المقارنة مِن ذلك الجاحد الذي لا يعترف بإلهٍ أصلًا، أو أولئك الذين يتخذون النار أو الحيوان أو الطبيعة آلهة لهم.
وعلى الرغم مِن تأكيدنا المستمر على شناعة شرك العرب بالله عز وجل وعبادتهم الأصنام، واتخاذهم أربابًا تقربهم إلى الله زُلْفى بزعمهم؛ غير أننا نقارن بين شركهم وبين كفر الآخرين، ليكون واضحًا للقارئ الكريم مدى رِفعْة العرب على غيرهم مِن الأمم، حتى في الجانب المظلم من حياة هذه الأمم، المتعلِّق بالكفر والشرك، فالعرب أقل حدة في الكفر مِن غيرهم، وأقرب للاستجابة والهداية لطريق إلهٍ يؤمنون بوجوده ممَّن لا يؤمن بوجود إلهٍ أصلًا.
إننا حين نقارن بين شرك هؤلاء وكفر أولئك سنتأكد مِن فضل العرب على غيرهم في هذا الباب المظلم أيضًا، وأن العرب كانوا أقرب مِن غيرهم إلى طريق الله عز وجل، والمعرفة به، والاستجابة لأوامره سبحانه، ولهذا كان العرب أكثر الناس سرعة للدخول في الدين الإسلامي، أكثر مِن عبدة النار أو الحيوان والطبيعة.
وعلى الرغم مِن معاداة سادة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، أولَ أمرِه، غير أن جحودهم وعداءهم لم ينبع مِن جحود الله عز وجل، وإنما نبع مِن الإصرار على تقليد الآباء والأجداد، واستبعاد أن تكون الآلهة إلهًا واحدًا بزعمهم، ﴿ أَجَعَلَ الآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [سورة ص: 5]، شيءٌ عُجاب في زعمهم أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل، ونفي الشركاء عنه، لكن حتى هؤلاء الكفرة الفجرة في خصومتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن فكرة وجود الله بعيدة عن عقولهم كما هو حال عُبّاد النار وغيرهم مِن أمم الأرض التي لا تدين بالدين.
وأؤكد مرارًا أننا لا نُهوِّن مِن شرك العرب وعبادتهم أصنامهم المزعومة، وإنما نقارن بين شركهم وكفر غيرهم مِن الأمم، لنؤكد على إقرارهم بوجود إلهٍ لهذا الكون، وضلالهم في طريق الوصول إليه، فأشركوا معه غيره.
فالمعركة مع الملحدين كانت في إثبات وجود إله، بينما كانت المعركة مع العرب في إثبات أحقيته على العباد بالأمر والنهي.
فانظر إلى هذه الآيات الكريمات:
يقول سبحانه: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت:61].
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت:63].
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان:25].
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزُّمر:38].
﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّخرف:84 – 89].
فهم يعترفون بوجود الله عز وجل، وبأنه خلقهم، وسخَّر لهم الشمس والقمر وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، يعترفون بهذا، لكن قست قلوبهم وضلَّت عقولهم عن طريق الله عز وجل، فاتخذوا وسائط بينه وبينهم، وعبدوا أصنامهم وأوثانهم التي لا تنفع ولا تضر، وتمسكوا بشرك آبائهم، ورياستهم، واستنكفوا أنْ يجلس الفقراء والضعفاء معهم في مجلسٍ واحدٍ، فيتساوى الجميع تحت لواء الإسلام، فرفضوا الانصياع، وآثروا الضلال والكفر، واستبدّتْ بهم الأهواء فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاولوا عليه، ورموه بالتهم، وشوّهوا صورته في أعين الضعفاء، فقالوا: ساحر، وقالوا: مجنون، وقالوا وقالوا، فردَّ الله كيدهم ونصر رسوله وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، والحمد لله رب العالمين.
ولسنا ندافع عن حماقات العقول، وقساوات القلوب الجاحدة للإيمان، لعنة الله على كل كفر، وإنما نقارن بين هؤلاء الجاحدين المتكبرين، وبين إخوانهم في الكفر والجحود، فاتضح أن الجحود أنواع وأشكال، وأن القوم يختلفون فيما بينهم، وأن العرب أفضل من غيرهم في هذا الباب، وأخفّهم في الضلال والكفر، وأقربهم نزوعًا للدين بما يعنيه ذلك من نزوعٍ للأخلاق.
ولاشك أن وجود بقايا مِن دين إبراهيم عليه السلام لدى العرب قد أثَّر في حياتهم هذا التأثير، وإِنْ خلطوه بطامة الشرك كما أشرنا، لكن لابد من الاعتراف بوجود بقايا مِن دين إبراهيم عليه السلام، بين العرب، والتاريخ يؤكد هذه الحقيقة.
قال الإمامُ ابن قُتَيْبَة رحمه الله: “العرب جميعًا من ولدِ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، خلا اليمن، ولم يزالوا على بقايا مِن دينِ أبيهم إبراهيم عليه السلام، ومِن ذلك: حج البيت وزيارته، والختان، والنكاح، وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثًا، وللزوج الرّجعة في الواحدة والاثنتين، ودية النفس مائة من الإبل، وتفريق الفراش في وقت الحيض، والغُسْل من الجنابة، واتباع الحكم في المَبَال[4] في الخنثى، وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصّهر والنَّسَب، وهذه أمورٌ مشهورة عنهم، وكانوا مع ذلك يؤمنون بالمَلَكَيْن الكَاتِبَيْن.
قال الأعشى – وهو جاهِلِيٌّ -:
فلا تَحْسَبَنِّي كافِرًا لك نَعْمَةً
عَلَى شَاهِدِي[5]، يا شاهِدَ اللهِ فاشْهَدِ
يريد على لساني يا مَلَك الله فاشْهَد بما أقول.
ويؤمن بعضهم بالبعث والحساب، وقال زهير بن أبي سُلمى[6] – وهو جَاهِلِيٌّ لم يلحق الإسلام – في قصيدته المشهورة التي تُعَدُّ من السَّبْع الطوال:
يُؤَخَّرْ فيُوضَعْ في كتابٍ فيُدَّخَرْ
لِيومِ الحسابِ أوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ
وكانوا يقولون في البَلِيَّةِ – وهي الناقة تُعْقَل عند قبر صاحبها فلا تُعْلف ولا تُسْقى حتى تموت -: إنَّ صاحبَها يجيء يوم القيامة راكبها، وإن لم يفعل أولياؤه ذلك بعده جاء حافيًا راجِلًا[7]، وقد ذكرها أبو زُبَيْد[8] فقال:
كالبَلايا رُؤُوسُها في الوَلايا
مانِحاتِ السَّمومِ حُرَّ الخُدودِ
والوَلايا: الْبَرَاذِع.
وكانوا يقوّرون الْبَرْذَعَة ويُدْخِلونها في عُنقِ تلكَ النَّاقَة.
وقال النابغة[9]:
مَحَلَّتُهُم[10] ذاتُ الإله ودِينُهُمْ
قَوِيمٌ فما يَرجُونَ غَيرَ العَواقِبِ
يريد: الجزاء بأعمالهم، ومحلتهم: الشام.

[cov2019]