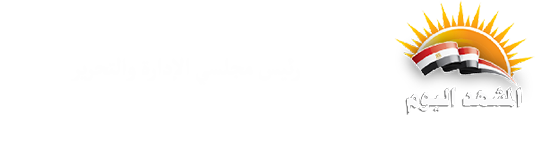رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن السؤال لرسول الإسلام في القراّن
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الرئيس التنفيذي لجامعة بيرشام الدولية بأسبانيا
مما لاشك فيه أن (السؤال) لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أخذ حيزاً كبيراً فيه؛ فقد ورد السؤال للنبي من القوم ست عشرة مرة، إحداها بصيغة الماضي في قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب} (البقرة:186)، وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع، كما في قوله سبحانه: {يسألونك عن الأهلة} (البقرة:189) إلا أن الجواب عليها مختلف، كلها صادرة عن الله الحكيم، فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له ملحظ، ومن هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم، ومنها ما سأله المؤمنون، السؤال من المؤمنين لرسول الله، وقد نهاهم أن يسألوه، إلا أنهم أرادوا أن يعرفوا رأي الإسلام في ما سألوا عنه، فكأنهم نسوا عادات الجاهلية، ورغبوا في أن تُشرع كل أمورهم على وفق الإسلام.
وبتأمل الإجابة على هذه الأسئلة نجد منها واحدة يأتي الجواب مباشرة دون قوله: {قل} وهي في قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع} (البقرة:186)، وواحدة وردت مقرونة بالفاء: {فقل} وهي قوله سبحانه: {ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا} (طه:105) وباقي الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل: {قل}، فما الحكمة في اقتران الفعل بالفاء في هذه الآية دون غيرها؟
قالوا: حين يقول الحق سبحانه في الجواب: {قل} فهذه إجابة على سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه بالفعل، أي: حدث فعلاً منهم، أما (الفاء) فقد أتت في الجواب على سؤال لم يسأله، ولكنه سيسأله مستقبلاً، فقوله تعالى: {ويسألونك عن الجبال} (طه:105) سؤال لم يحدث بعد، فالمعنى: إذا سألوك {فقل}، وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع مستقبلاً، فكأن (الفاء) هنا دلت على شرط مقدر، بمعنى: إن سألوك بالفعل، فقل: كذا وكذا. إذن: السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية، أما الأسئلة الأخرى فكانت موجودة، وسئلت لرسول الله قبل نزول آياتها.
ثم لسائل أن يسأل: فما الحكمة في أن يأتي الجواب في قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب} (البقرة:186) خالياً من: {قل} أو {فقل}؟ قالوا: لأن السؤال هنا عن الله تعالى، ويريد سبحانه أن يجيبهم عليه بانتفاء الواسطة من أحد؛ لذلك تأتي الإجابة مباشرة دون واسطة.
في سورة البقرة وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة في سياق واحد، وذلك قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} (البقرة:219-220) أسئلة ثلاثة وإجابتها، وكلها يتصل بإصلاح المجتمع، وتقوية بنيانه، وكل واحد منها يتجه إلى ناحية إصلاحية، وكلها يتلاقى نحو مقصد واحد، وهو إقامة بناء المجتمع على دعائم من الفضيلة والمودة والتعاون على الخير، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وقد جاءت هذه المعاني الإصلاحية التي توثق الوحدة، وتقوي الروابط بعد الأمر بالجهاد مع بعض أحكام القتال، {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (البقرة:216)؛ لأن القتال حماية للدولة من أن يلتهمها العدو الخارجي، والإصلاح في هذه المسائل الثلاث يتناول حماية الأمة من أن تأكلها نيران العدو الداخلي، وهو التنابذ، وأن تنظر كل طائفة للأخرى نظر العدو المترصد، لا نظر العضو المتعاون والأخ المتودد؛ ولأن الوحدة الداخلية والاتحاد المكين عدة القتال، وذخيرة الحرب، فقوة الحرب تستمد من السلم؛ ولأن مقصد الإسلام الأسمى هو إيجاد جماعة متآخية متحابة على أسس من الفضيلة والخلق الكريم، ولكنه ما إن دعا بدعوته، حتى خرج عليه إخوان الشيطان يحاولون أن يبيدوه، وأن يقضوا عليه في مهده، وفُتن المسلمون في دينهم، وعُذِّبوا في إيمانهم عذاباً شديداً، فـ {أُذِنَ للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا} (الحج:39)، وساروا على سنَّة الوجود، وهو أن يدفعوا ذلك العدو المعتدي الذي يريد الفتك بهم، حتى إذا دفعوه وأمنوا شره، أو فلوا قوته، وأوهنوا شوكته، اتجهوا إلى إقامة مدينتهم الفاضلة، وإرساء قواعدها وحققوا بهذا القصد الأول، ومكنوا لأنفسهم وأعدوا بالفضائل عدة أقوى لمنازلة الأعداء.
وقد ابتدأ القرآن الكريم في إصلاح المجتمع الإسلامي بهذه المسائل والإجابة عنها؛ لأنها هي التي تنفي الأذى، وتدفع الخطر الاجتماعي، ومن المقرر عند علماء الإسلام أن التخلية مقدمة على التحلية، أي أن نفي الإثم مقدَّم على جلب النفع، وأن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المنفعة؛ إذ إنه لا منفعة مع فساد يشيع، وداء يستشري، وأذى يستمكن، ومثل الجماعة في علاجها من أدوائها، كمثل الجسم الإنساني في علاجه من أمراضه، فإن الطبيب الماهر لا يبادر بتقوية الجسم، ويترك الجراثيم تفتك به، بل يجتهد أولاً وبالذات في محاربة هذه الجراثيم والقضاء عليها، ثم يقوي الجسم، وإن عمد إلى التقوية في أثناء العلاج فلتقوى المقاومة، ولتزداد الحصانة، ولتشتد المناعة وغرضه الأول محاربة الآفات، وكذلك الأمر في إصلاح الأمم: يُبتدأ بإماطة الأذى الذي يفتك بها، ثم يُثنَّى بأعمال الإنشاء، التي تقيم البناء.
السؤال الأول جاء فيه قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} السؤال عن الخمر والميسر هو بلا شك عن الحل والتحريم، لا عن الحقيقة والذات، فإنهم يعرفونهما بلا شك، وكان الأغنياء وذوو المقدرة فيهم منغمسين فيهما، ولذلك كان الجواب مشيراً إلى عدم رضا الشرع عنهما، أو مشيراً إلى تحريمهما؛ لأن ما غلبت مضرته على منفعته يكون حراماً، ولا يكون حلالاً، وقد صرح سبحانه بذلك، فكان يحق على المؤمن النقي النفس، الذي خَلَصَ من أدران الهوى، أن يكتفي بذلك ويجتنبهما، وكذلك فعل خواص المؤمنين، والعلية من أصحاب الرسول الأمين صلى الله علبيه وسلم، كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم من السابقين المقربين. ولقد كان عمر رضي الله عنه يحس بأن شرب الخمر لا يسوغ في الإسلام، ولذا كان يدعو الله قائلاً: اللهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً، خصوصاً بعد أن نزلت الآيات التي تشير إلى التحريم، ولا تصرح به.
ولماذا كان السؤال عن الخمر والميسر، وممن كان السؤال؟ إن السؤال بلا ريب من المؤمنين، ولم يكن من غيرهم؛ لأنهم رأوا الخمر تُذْهِب الرشد، وتُضْعِف العقل، وتجعل المرء يقع فيما لا يحسن، حتى أنه ليُروى أن حمزة بن عبد المطلب شرب الخمر، فعقر ناقة لعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قد أعدها ليحتطب عليها، ويجمع بذلك مهر فاطمة الزهراء، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ولما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كان سكران، فقال للرسول الكريم: ما أنتم إلا عبيد أبي! فما كان المؤمنون الأولون، وقد أرهف الإيمان قلوبهم، وزكت أرواحهم، وطهرت نفوسهم ليرضوا عن الخمر، وإن لم يصرح القرآن بالتحريم، ولذلك كثر سؤالهم عنها، ليكون القطع في أمرها.
أما السؤال الثاني فقد جاء في قوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون}، ومناسبته للسؤال الأول أنهم كانوا يتخذون من الخمر والميسر طريقاً لتسخية نفوس الأشحة على الخير، الذين لا يجودون من تلقاء أنفسهم، فكان السؤال عن الإنفاق على البر، عقب السؤال عن الأمر الآثم، الذي كانوا يحسبونه بِرًّا، وهو إثم لا بِرٌّ فيه. وفي الإجابة عن هذا السؤال بيان طريق العطاء المنظم المعلوم الخالي من الإثم، بدل العطاء المجهول غير المنتظم المشوب بالإثم الذي أحاط به. سألوا عما ينفقون من مال في البر، فقال لنبيه: {قل العفو} أي: السهل الزائد عن حاجتكم الأصلية، الذي لا يشق عليكم بذله، إن استقامت النفوس، وامتلأت القلوب بالإيمان، وعمرت بالرحمة، وأجابت نداء الرحمن. ولقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة، فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معه فَضْلُ ظَهْرٍ، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له)، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل). رواه مسلم.
وأما السؤال الثالث فقد جاء فيه قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} (البقرة:220)، والإجابة فيه وأساسها أيضاً إماطة الأذى عن الجماعة الإسلامية، فإنه إذا كان الإنفاق على الفقراء يحمي المجتمع من الفقر وأهواله وغوائله، فحماية اليتامى وكلاءتهم تحمي المجتمع من أن يكون منهم شريرون يبغضون المجتمع، ويجلبون له الويلات، وهم في كنف المجتمع ورعايته. لقد سألوا عن اليتامى أيضمونهم إليهم، ويأكلون معهم، أو يدعونهم وأموالهم، وكيف يرعونها، وكيف يقومون عليها؛ سألوا هذه الأسئلة وما يشبهها، وقد قرأوا قوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر} (الضحى:9) فكانوا من أمرهم في حيرة: إن قاربوهم وأموالهم، يخشون على أنفسهم أن ينالوا إثماً، وإن تركوهم ضاعوا، وهم في كفالة المجتمع كله، فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إن المطلوب إصلاحهم، فقال سبحانه: {قل إصلاح لهم خير} أي: أن المطلوب إصلاحهم وإصلاح مالهم، وذَكَرَ إصلاحهم؛ لأنه المقصد الأول، ولأن إصلاح مالهم إصلاح لهم، وخير لكم ولهم، وإصلاح حالهم بالتهذيب والتربية والعطف والمحبة، والرأفة، وعدم تكليفهم ما يشق عليهم، لأن الغلظة معهم تربي فيهم الجفوة، وتنشأ عنها القسوة، فينشئون وهم يبغضون الناس، ويتربصون بهم الدوائر. وإذا كان المطلوب هو (الإصلاح) بكل وسائله، وهو الغاية المطلوبة، فإن كان الإصلاح بمخالطتهم، وضمهم إليهم من غير أن تؤكل أموالهم، فالمخالطة سائغة جائزة، ولذا قال سبحانه: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} أي: عند المخالطة استشعروا أنهم إخوانكم في الدين والإنسانية وأبناء إخوانكم، وعاملوهم بتلك الرابطة الأخوية الرحيمة، ولا تنظروا إليهم شذراً، وتؤكلوهم نزراً؛ لأنهم غرباء عن بيتكم، بل أشعروهم بأنهم دائماً في بيت أهلهم وذويهم، حتى لا تتربى نفوسهم على الجفوة، فيبغضوا الناس، ويتربصوا بهم الدوائر، ويكون ذلك في طبعهم إذا كبروا وبلغوا أشدهم.
وهذه الأسئلة وما شاكلها -كما يقول سيد رحمه الله- ذات دلالات شتى:
فهي أولاً: دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها، وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة، ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً، فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين، ولا تلك القبائل المتناثرة. إنما عادوا أمة لها كيان، ولها نظام، ولها وضع يشد الجميع إليه، ويهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته، وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء، حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام.
وهي ثانياً: دليل على يقظة الحس الديني، وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس، ما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمراً في حياته اليومية، قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه، فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة يرجعون إليها، وقد انخلعت قلوبهم من كل مألوفاتهم في الجاهلية، وفقدوا ثقتهم بها، ووقفوا ينتظرون التعليمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي ينشئها الإيمان الحق. عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها، وتقف موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه في جاهليتها، وتقوم على قدم الاستعداد؛ لتلقي كل توجيه من العقيدة الجديدة، لتصوغ حياتها الجديدة على أساسها، مبرأة من كل شائبة. فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيهاً يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم، تلقته جديداً مرتبطاً بالتصور الجديد؛ إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم، ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد، فتصبح جزءاً منه، داخلاً في كيانه، متناسقاً مع بقية أجزائه، كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها. فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي، وتقوم على قواعده، وأنبتَّت علاقتها بالتصورات الجاهلية نهائيًّا.
والدلالة الثالثة: تؤخذ من تاريخ هذه الفترة، وقيام اليهود في المدينة، والمشركين في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم الإسلامية، وانتهاز كل فرصة للقيام بحملة مضللة على بعض التصرفات والأحداث -كما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وما قيل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم- ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها، بما يقطع الطريق على تلك المحاولات، ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين، ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائماً في المعركة، سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام، والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب.
هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة؛ فالنفس البشرية هي النفس البشرية، وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها، والقرآن حاضر، ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة، ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة، وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة، فلا فلاح لهم ولا نجاح! وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس، أن تُقْبِل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور. أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجديد، ويقاوم تصورات الجاهلية، ويدفع عن هذه الأمة، يقيها العثرات، لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل، وكلاماً جميلاً يتلى، وينتهي الأمر، إنه لأمر غير هذا نزَّل الله القرآن، لقد نزَّله لينشئ حياة كاملة، ويحركها، ويقودها إلى شاطئ الأمان بين الأشواك والعثرات، ومشقات الطريق التي تتناثر فيها الشهوات، كما تتناثر فيها العقبات.