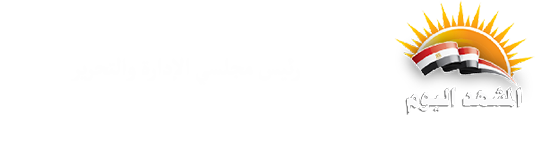رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن اللغة العربية لغة الدين والدنيا
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الرئيس التنفيذي لجامعة بيرشام الدولية بأسبانيا
مما لا شك فيه أن هناك حقيقة لغوية يؤيدها الواقع ويؤكدها التاريخ، وهي ارتباط اللغة –أي لغة- بحضارة أصحابها: اللغة والحضارة يتناسبان تناسباً طردياً؛ هذا يعني ببساطة أن اللغة ظاهرة اجتماعية تعيش مع الإنسان جنباً إلى جنب، تضعف بضعفه، وتنمو وتزدهر بنموه وازدهاره.
ولغتنا العربية تعد مثلاً لهذا في عصورها المختلفة، فقد كانت لغة بسيطة في بداية أمرها عندما كان المجتمع العربي نفسه لا يملك من مقومات الحضارة إلا الشيء القليل، حتى جاء الإسلام اتسعت هذه اللغة واحتوت كل العلوم والمضامين التي جاء الإسلام بها.
وللغة العربية ميزة فريدة هي: شرف نزول القرآن الكريم بها على الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم -، أفصح العرب قاطبة، فحفظها وحفظته.
هذا التشريف هو ما أنزلها منزلة سامية لدى كل من ارتضى الإسلام ديناً. ووصلت بطريقة أو بأخرى إلى باكستان، وأفغانستان، وبعض مقاطعات الاتحاد السوفييتي، والهند وماليزيا. كما استقرت في مناطق أخرى في أفريقيا وأوروبا، وفي العصور الحديثة أتيح للغة العربية أن تحتك باللغات الأوروبية، فتأثرت وأثرت بهذه اللغات عن طريق الترجمة، والبعثات، والمبادلات المختلفة.
لقد وعى العرب والمسلمون أهمية لغتهم، وارتباطها بالقرآن الكريم، فبادروا بدراستها، والحفاظ عليها، فما أن رأوا شيوع اللحن نتيجة لاختلاط الناطقين بها بغيرهم من العجم في البلدان المفتوحة، حتى سارعوا بضبط المصحف كما فعل أبو الأسود الدؤلي، ووضع علم النحو، وتقعيد القواعد بطريق الرواية والمشافهة عن الأعراب الخلّص، فلم يقبلوا من فسد لسانه للأخذ عنه، لمجاورته العجم أو اتصاله بهم من القبائل. أقول: إن الدافع الديني كان من الأسباب – إن لم يكن السبب الوحيد – التي حدت بالعرب إلى قيامهم بعملهم هذا، وإن الحرص على الفصحى لغة القرآن الكريم هو الذي جعل العرب والمسلمين يقفون صفاً واحداً ينافحون عنها ويبعدون عنها كل شائبة. ولذات السبب أيضاً رأينا اللغويين في عصور الازدهار الإسلامي يؤلفون المؤلفات، ويخطون الرسائل في خدمة العربية، فها هو أبو منصور الثعالبي النيسابوري يقول في مقدمة كتابه فقه اللغة وسر العربية: (من أحب الله – تعالى – أحب رسوله محمداً – صلى الله عليه وسلم -، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب، على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عُني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام، وشرح صدره للإيمان، وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمداً – صلى الله عليه وسلم – خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعايش والمعاد. ثم هي لإحراز الفضائل، والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب، كالينبوع للماء، والزند للنار..).
قوة اللغة بقوة أصحابها:
لقد كانت اللغة العربية قوية أيام قوة أصحابها، ورهبة الأعداء من المساس بالمسلمين بأي أذى، أما عندما تفككت الوحدة، وفتّ من عضد الدولة الإسلامية، تآمرت الدول الحاقدة عليها، وبدأت تنهش جسدها المنهوك. حدث هذا زمن الحملات الصليبية، وكذلك ما عانته الأقطار الإسلامية على يد الاستعمار الحديث. لقد جثم هذا الاستعمار طويلاً على صدر المسلمين، وكان يهدف –من بين أهدافه الخبيثة- طمس اللسان العربي، وبذلك يحول بين المسلمين ودينهم المدون بهذا اللسان. برز هذا بصورة واضحة في أقطار المغرب، وخاصة في الجزائر حيث سعى الاستعمار الفرنسي إلى فرض لغته مكان العربية، وعمل جاهداً على إحياء اللهجات المحلية لتحل محل العربية الفصحى.
وقد أوكل الاستعمار الإنجليزي لبعض أعوانه هذه المهمة في مصر، فكانت دعوة وليم ويلكوكس لاتخاذ العامية لغة للتأليف والتعليم، ولكونه مهندساً للري، فقد حاول هذا العميل تغليف دعوته تلك بثوب علمي. وقد أثار هذا الموضوع في محاضرة ألقاها في نادي الأزبكية سنة 1893م حيث كان السؤالُ: لِمَ لمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى الآن؟ مدارَ تلك المحاضرة. وقد عزا ويلكوكس عدم وجود هذه القوة إلى العربية الفصحى! وتبع ويلكوكس هذا قاضٍ إنجليزي آخر هو سيلدون ولمور الذي نشر كتاباً عام 1901م أسماه العربية المحكية في مصر. وكان د. ولهلم سبيتا قد ألف كتاباً مماثلاً. وأيا كانت وسائل هؤلاء، فقد كان الهدف الذي يسعون إليه واحداً، وهو سلخ المسلمين عن دينهم وتراثهم المشرق. وللأسف فقد جاء من بعد هؤلاء المستعمرين المبشرين، بعضُ العرب في مصر والمغرب ولبنان، ممن يعدون أذيالاً للاستعمار، أو ممن خدعوا بهذه الدعوات المضللة. ثم اتخذ الهجوم على اللغة العربية الفصحى شكلاً آخر تمثل في الدعوة إلى نبذ الحروف العربية، واستبدال الحروف اللاتينية بها، كما فعل كمال أتاتورك عندما ألغى الخلافة سنة 1924م. وكان من دعاته د. دواد الحلبي الموصلي، وعبد العزيز فهمي، وغيرهما. وقد قوبلت هذه الدعوات وأمثالها بالاستنكار الشديد من كل الغيورين على هذه اللغة، فذهبت أدراج الرياح، ولم تصغ إليها سوى آذان حاقدة لا تأثير لها.
يتضح من هذا العرض السريع لمحاربة اللغة العربية، أن الأهداف التي سعى الاستعمار لتحقيقها كانت دينية في المقام الأول، وكذلك عزل العرب وتفرقتهم كل في بيئته، ومن هنا نفهم استيقاظ الدعوات الإقليمية المنتنة –بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم- من فرعونية، وآشورية، وبربرية، وفينقية.
والآن نتساءل: هل لغتنا في أزمة؟ ولنترك الجواب للواقع اللغوي يترجم الحال.
تبرز على الساحة اللغوية عندنا ثلاثة مستويات أو أنماط: فصحى التراث، وفصحى العصر، ثم تأتي اللهجات العامية –على اختلاف مستوياتها واستعمالاتها- قاسماً مشتركاً بين هذه المستويين. وبدايةً نؤكد أن العامية تستعمل لغة للتخاطب اليومي في البيت أو في الشارع، للإعراب عن الحاجات الملحة للإنسان، وهي بهذا الوضع كانت موجودة في القديم، ولا ضرر من هذا الوجود الطبيعي لها.
فصحى التراث وفصحى العصر:
أما ما درج الباحثون على تسميته بفصحى التراث، فالمقصود بها اللغة العربية التي احتفظت بخصائصها النطقية والتركيبية.. بحيث لم يدخلها –في مجملها- ما دخل العربية المعاصرة من ألفاظ وتراكيب وأساليب حديثة. والملاحظ على فصحى التراث أن استعمالها أصبح الآن قاصراً على الموضوعات الدينية والتاريخية، فلا نقرأها إلا في كتب التراث القديمة، وفي الموضوعات الدينية، ولا تسمعها إلا من خطباء المساجد، وعلماء الفقه، وذوي الثقافة التقليدية. وأما ما يسمى بفصحى العصر، فتمثله وسائل الإعلام على اختلافها. وهي لغة التأليف العلمي والأدبي في معظم كتابات كتّاب هذا العصر. وهي اللغة المسموعة من ألسنة المذيعين والصحفيين. وتمتاز هذه اللغة بتحررها مما في فصحى التراث، فإذا سمعنا قارئي الأخبار، سمعنا تسكيناً لأواخر الكلمات، ونطقاً مخالفاً في بعض الأصوات، وضياعاً لقواعد نظام العدد، وأسماء الأعلام، ثم تراكيب وألفاظاً ذات مسحة أجنبية بفعل الترجمة.
والملاحظ أن هذين المستويين من اللغة – فصحى التراث وفصحى العصر – لا يفصل بينهما فاصل، أي أن إحداهما في أقصى اليمين، والأخرى في أقصى الشمال، ولعل مشكلة ضعف تلاميذنا وطلابنا تكمن في هذا الفصل الحاد. فالطالب يقرأ لغة مغايرة للغة كتب التراث القديمة، مما يولد لديه صعوبة في فهم ما في هذه الكتب وبالتالي كراهية لها، ونفوراً منها. ولعل ما يزيد المشكلة تعقيداً هو عدم التزام جل المدرسين والمثقفين باللغة الفصحى، سواء في المدرسة، أو في الجامعة، أو من خلال وسائل الاتصالات المختلفة، فلا نسمع إلا “دردشات” بالعامية بين مثقفينا، وإن حضرت مناقشة لرسالة للماجستير أو الدكتوراه في جامعاتنا فاللغة في المناقشة هي العامية! حتى لو كان موضوها في النحو العربي! ونتيجة هذا كله ضعف لدى الطلاب في لغتهم، وشكوى من صعوبتها، وبالتالي تحولهم عن دراستها.
ونحن لا ننكر التطور الطبيعي للغات، فهذا دليل حيويتها ومرونتها، ولكن التطور لا يعني هذا التسيّب في ضياع الهوية للغتنا، ولا جنوحاً إلى التقليد الأعمى للأجنبي، لا لشيء سوى الولع بتقليد الغالب.
إن لغتنا التي وسعت ألفاظ حضارات كثيرة لقادرةٌ على استيعاب كل جديد. وهي التي حملت الدين الإسلامي طيلة أربعة عشر قرناً، سوف تبقى قادرة على إعانة المسلمين على فهم دينهم، وتبصرتهم به.
ولا يتأتى هذا إلا بدراستها على مستوييها قديماً وحديثاً دراسة شاملة من أبنائها المخلصين، ثم رصد هذه الدراسة، واستخلاص النتائج، لتذليل الصعاب، وبيان المشكل، من أجل التقريب بين المستويين تقريباً يمكن أي دارس من فهم القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وتراثنا المشرق، وفي ذات الوقت يستوعب الحضارة الحديثة بعلومها وآدابها.

[cov2019]