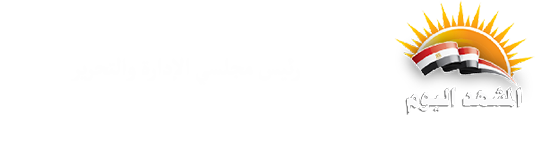رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن صفات الداعية
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
من المعلوم لدى كل مسلم أنَّه مُطالَب بالدعوة إلى الله تعالى في كل حين وآن، وفي كل عصر ومصر، والإسلام دين يطالب أتباعه والمنتمين إليه أن يفكروا في الإنسانية كلِّها، ويقوموا بتبليغ رسالة الله تعالى الخالدةِ إلى البشرية جمعاء؛ من أقصى الأرض إلى أقصاها، دون التفرقة في اللون أو الجنس، ويأمرهم بأداء واجبهم تجاه العالم كلِّه الذي يُعاني المصائب والأزمات؛ بسبب الخوض في غمرات الجاهلية، وبسبب الابتعاد عن المنهج القويم الذي يَهديه إلى الطريق القوي المستقيم؛ فإن العالم لفي أمسِّ حاجة إلى من يأخذ بيده، وينتشله من الوقوع في الهوة العميقة من الهلاك والبوار.
وكان من رحمة الله تعالى على هذه الإنسانية التائهة البائسة أنه أرسل إليها عباده المصطفَيْن أنبياءً ورسلًا في مختلِف الأزمان والعصور، وفي مختلِف البقاع من هذه المعمورة، فقاموا بواجبهم أحسنَ قيام، وبلغوا الرسالة وأدَّوُا الأمانة الإلهية التي وُكِلت إليهم وأُلقيت على كواهلهم، وقاموا بالحجة.
وفي الأخيرِ بعث خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مسك الختام لعلاقة الأرض بالسماء؛ حيث انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم، وألقيت هذه المسؤولية على كواهل الأمة وانتقل هذا العبءُ إلى علمائها؛ ليَدْعوا إلى الله تعالى ويُنقذوا البشرية من الضلال، ويخرجوها من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعَتِها، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام؛ الذي – بصفته دينًا جامعًا – بيَّن لهم معالم الطريق الدعوي، وأرشدهم إلى السبيل القويم، وكلَّفهم باتباع الأنبياء والمرسلين، وخاصة النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم في شؤون الدعوة والإرشاد، فقد جعَل لهم فيه أسوة في كل أمر؛ ليكونوا على بصيرة، ويدعوا إلى الله تعالى بوعي كامل، كما قال الله عز وجل في الذكر الحكيم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21]، فمن اتبعه اتباعًا كاملًا، وجعل حياته المباركة أسوة، واهتدى بهديه؛ فاز في دنياه وعُقباه، ومَن أعرض عنه وسلك مسلكًا آخر، معتقِدًا بأنه على الطريق الأمثل للدعوة إلى الله تعالى؛ فلا يتحقق له ما يريد من نشر الدين الحنيف وتوجيهاته الرشيدة، وابتغاء مرضاة رب العالمين.
والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خير نماذجَ لاتباع الرسول عليه الصلاة والتسليم، فقد كانوا يَحْذون حذوَ النبي صلى الله عليه وسلم نعلًا بنعل، ولا يَحيدون عن امتثال أوامره قِيدَ أَنمُلة، وكانوا يقدِّمون التضحيات من النفس والمال؛ لنشر الدعوة الإسلامية؛ ابتغاءً لمرضاة الله تعالى، ويقاومون الكفَرة والضالين والطغاة، إنهم كانوا تلاميذَ مُعلِّم البشرية، الذي علَّمهم كل ما يحتاجون إليه، بل كلَّ ما تحتاج إليه البشرية حتى قيامِ الساعة، فأخَذوا منه الدين الحنيف بمبادئه وأصوله، وقِيَمه وسلوكه، وأموره في مجالات الحياة كلِّها؛ من السياسة والثقافة، والاجتماع والاقتصاد، وانتشروا بها في العالم متمسكين بوصاياه التي وصَّى بها عند مغادرتهم المدينةَ المنورة، فالتاريخ يشهد أنهم فازوا في مرامهم، وحقَّق الله تعالى لهم ما أرادوا، وبفضل جهودهم الحثيثة واتباعهم الخالص للرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم؛ انتشر هذا الدين من أقصى العالم إلى أقصاه.
وها نحن هنا ندرس أهم الصفات التي كانت تتصف بها هذه الفئة المؤمنة الصادقة؛ لتكون نبراسًا للدعاة إلى الله تعالى، ولكي يُنشِئوا في أنفسهم هذه الميزات، ونفيد مما قام به علماؤنا من استخراج هذه الصفات من سِيَرهم، ومُتابعتِهم عليها، وهي على النحو التالي:
إخلاص النية:
من أهم ما يتصف به الداعية إخلاص النية؛ لأن ذلك يؤثر عليه في كل ما يقدم من قول أو عمل، وإخلاصُ النية أساس العمل في الإسلام، والأعمال سرُّ قَبولها في إخلاص النية؛ حيث لا يكون العمل مقبولًا، ولا ينفع صاحبه إذا كانت النية فاسدة أو غيرَ خالصة لوجه الله تعالى، وبالإخلاص ينزل من الله تعالى النصرُ والعون، والمخلص يُنعِم عليه الله تعالى كثيرًا؛ حيث يضَع له القَبول في الأرض، ويفتح له أفئدة الناس، وبإخلاصه تلين القلوب القاسية.
ويقول العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى: “وقد جرَت عادة الله التي لا تُبدَّل، وسُنَّته التي لا تحوَّل أن يُلبِس المخلصَ من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق، وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسَب إخلاصه ونيته، ومعاملته لربه، ويُلبس المرائيَ اللابس ثوبَيِ الزور من المقت والمهانة والبِغْضة ما هو اللائق به؛ فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقتُ والبغضاء”[2].
فلا بد للداعي أن يخلص نيته قبل أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، ويعتقدَ أن الدعوة عبادةٌ مثلُ العبادات الأخرى؛ يجب فيها إخلاص النية؛ امتثالًا لقوله جل وعلا: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: 5]، ويقصد بدعوته التقرب إلى الله تعالى، ويبتغي مرضاته، وينوي أنه بعمله هذا ينصر دينه، ويحاول إصلاح إخوانه من عباد الله تعالى، ويخرجهم من ظلمات الجهل والعصيان والشرك، إلى نور العلم والطاعة والتوحيد.
التعمق في العلم:
إن العلم أساس الإسلام، وأول ما نزل من الوحي الإلهي كان أمرًا بالقراءة والحصول على العلم، ومنه تتَّضح أهمية العلم في الإسلام، إذًا فلا بد لمن يدعو إلى هذا الدين المتين أن يكون عالِمًا؛ بل يجب أن يكون متعمقًا في العلوم الشرعية، ومتقنًا لها، ويعرف مبادئ الدين وأصولَه، ويكون راسخًا في أمور العقيدة، ويخضع للقرآن والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة وفقهاؤها، ولا يُحدِث مِن هواه ما ليس من الدِّين، ولا يعتقد نفسه عالِمًا؛ بل يجب عليه أن يرجع دومًا إلى المصدرَين الأساسين للشريعة، ويَنظر فيما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والأئمةُ الأعلام الذين درَسوا هذين المصدرين واستخرَجوا منهما أحكام الشرع.
وذلك لأن من يجهل العلوم الشرعية والمصدرين الأساسين لها؛ فإنه يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه، وقال أحد العلماء في عصرنا: على الداعية أن يكون على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكزٍ على كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل علم يُتلقَّى من سواهما يجب أن يُعرَض عليهما أولًا، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقًا أو مخالفًا؛ فإن كان موافقًا قُبِل، وإن كان مخالفًا وجب ردُّه على قائله كائنًا من كان، والدعاة في زمننا هذا يقولون بألسنتهم مِن هوى أنفسهم، ويتكلمون في الشريعة بدون علم، يُحلُّون ما حرمه الله تعالى ويُحرمون ما أحله، ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولًا أو عملًا لم يَثبُت عنه، وينسَوْن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ كَذِبًا عليَّ ليس ككَذِبٍ على أحدٍ؛ مَن كذَب عليَّ مُتعمِّدًا فلْيَتبوَّأْ مَقعدَه مِن النَّار))[3]، فليَحذروا من الحديث في أمور الدين دون التحقُّق منها.
البصيرة:
من أهم صفات الداعية المستخرَجةِ من كتاب الله تعالى أن يقوم بعمل الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: 108].
والبصيرة على ثلاثة أقسام:
1- أن يكون على بصيرة؛ أي: على علم بما يدعو إليه؛ يَعرف الحكم الشرعيَّ من الحلال والحرام، فلا يُحل ما حرَّمه الله تعالى، ولا يُحرِّم ما أحله الله تعالى.
2- أن يكون على بصيرة من أحوال المدعوِّ وظروفه؛ فإن القوم الذي يدعوهم لا بد له من أن يكون على علم بعقائدهم ودينهم وظروف مجتمعهم الدينية والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية؛ لأن ذلك يحمله على أن يكلمهم على قدر عقولِهم، فمثلًا لو ذهب داعية إلى الله تعالى إلى قوم يجهَلون العلوم الحديثة وما أنتجته التقنية الجديدة من الوسائل والآلات، فيقوم بينهم هذا الداعي ويَدعوهم إلى التفكير في قدرة الله تعالى، ويضرب لهم الأمثال من هذه الوسائل والآلات، ويُثبِت الحقَّ بها فإنه أمر لا يُجديه نفعًا! لا بد له أن يتكلم على قدر عقول الناس ومستواهم العلمي والحضاري.
وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس على بصيرة، فحينما كان يرسل الدعاة إلى الأمصار والبلاد كان يوصيهم ويخبرهم بكل ما يدعو إليه، فلما بعث معاذَ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: ((إنَّك تَقْدَم على قومٍ أهلِ كتابٍ، فلْيَكنْ أوَّلَ ما تَدْعوهم إليه عبادةُ الله، فإذا عرَفوا الله فأخبِرهم أن الله قد فرَض عليهم خمسَ صلَواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فعلوا فأخبِرهم أنَّ الله فرض عليهم زكاةً تُؤخَذ مِن أموالِهم وتُرَدُّ على فقرائِهم فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناس))[4]، فلا بد للداعي أن يطَّلع على أحوال القوم المَدعوِّين وظروفِهم، ويتابع المجلات والجرائد التي تتحدث عنهم.
3- أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة، وهذا ما يَفقده كثير من الدعاة المخلصين؛ يقومون في أوساط الناس ويَدعونهم بحماس واندفاعٍ في مكان يتطلب الدَّعَة والوقار، وهذه هي الحكمة المطلوبة التي أمرنا الله تعالى بها في الآية الكريمة: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]؛ فلا بد أن يسلك طريقًا قويمًا يُناسب الدعوة الإسلامية، ويبشِّر ولا ينفِّر، ولا يسلك طريق الهوى والاندفاع؛ بل يأخذ الأمور بجدية؛ متبعًا سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسنَّته المباركة.
الحكمة:
وقد بين الله سبحانه وتعالى منهج الدعوة في الآية المذكورة، وأوضح للدعاة الأسلوب الأمثل للقيام بهذه المهمة العظيمة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد جسَّد هذا الأسلوب الدعوي قولًا وعملًا، واتبعه الصحابة البرَرة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي الحكمة، ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: 269].
والحكمة هي حُسن مخاطبة الآخرين في الوقت المناسب، والمكان المناسب، وبالأسلوب المناسب؛ لكي يصل الداعي إلى الهدف المنشود، ويتحقق له ما يريد؛ من إثمار دعوته، وتَوجُّه الناس إلى الرب جل وعلا، باستِمالة قلوبِهم وتحريك عقولهم وضمائرهم، وتسديد خطاهم؛ فلا بد للداعي إلى الله تعالى أن يتعلم الحكمة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
والحقيقة أن لفظة (الحكمة) تحمل أبعادًا كثيرةً ودلالاتٍ متنوعة ومعانيَ عميقة، وتجمع عناصر الخير كلَّها التي لا يمكن حصرها في هذه الصفحات.
الموعظة الحسنة أو اللين والرفق في الكلام:
الأمر الثاني الذي أُمر به الداعي في قولِ الله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: 125] هو أن يُرغِّب الداعي إلى الله تعالى ترغيبًا حسنًا، يبشِّر ولا يُنفر، ويَعرض كلامه عرضًا مشوقًا، ويستخدم أسلوبًا عذبًا، ويتكلم بكلام ليِّن رقيق، ويلقي الكلمة الطيبة، ويَلقى الناسَ بوجه طلق وثَغرٍ باسِم، وصدر رحب، ولا يضيق ذرعًا ولا يَعبِس وجهُه، يقدِّم الحلول والعلاجَ للأمراض التي تعانيها البشرية، ويصبر على المخالفة والأذى وعلى جهل المدعوِّين، وله أمثلةٌ كثيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه وَسِع الصحابةَ رضي الله عنهم وغيرَهم بخُلقه الكريم وقلبه الرحيم وكلامه الطيب رغم المخالفة الشديدة، فلم يقسُ عليهم في الكلام، بل استخدم الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة كأداةٍ نافعة، فاجتمعوا حوله وآزروه وساعدوه في اليسر والعسر، وصاحَبوه في الشدة والرخاء، وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: 159].
إذًا يجب على جميع الدعاة أن يَدْعوا الناس بالموعظة الحسنة، ويجتنبوا قسوة الكلام وشدته، ويستخدموا أسلوبًا لينًا، ويبينوا أمام الناس مظاهر قدرة الله تعالى؛ ليفكروا فيها ويعودوا إلى الرشد والصواب، وعلى الدعاة أن يبرزوا مميزات الإسلام وخصائصَه ونفعها للإنسانية، وما آل إليه مصير الإنسانية بسبب البعد عن تعاليم الله، وكل ذلك بأسلوب يجذب الانتباه، ويَلفِت الأنظار، ويدعو إلى التفكر فيها.
الجدال المثمر:
الأمر الثالث المطلوب في العمل الدعوي المذكور في الآية الآنفة هو الجدال الحسن؛ أي: الحوار المثمر البنَّاء، وهذا الأمر له أهمية كبيرة في عصرنا هذا؛ إذ نجد بعد العولمة أن الحوار أصبح من أهم الأدوات النافعة للتواصل البشري، فيجب على الداعي أن يتعلَّم أسلوب الحوار، ويجعل حواره نافعًا مثمرًا، لا بد له أن يدرس نفسية المخاطَب قبل أن يخاطبه، ويختار أفضل السبل وأيسرَها للوصول إلى ذهن المتلقِّي، ويقنعه بحواره وكلامه إقناعًا تامًّا؛ حيث لا يشعر المخاطب أنه رجل ألحَنُ وأبلغ في الكلام، ويريد أن يغلب عليه في الجدل، فيترك له المجال ليثبت براعته، ولكن الهدف الحقيقي وراء هذا الحوار لا بد أن يكون الإقناعَ والوصولَ إلى الحق، ويشعر المخاطبُ أن الداعيَ لا يريد إلا كشف الحقيقة، دون إيذاء الآخرين أو النَّيل من كرامتهم.
وهناك صفات أخرى كثيرة لها أهميتها في الدعوة إلى الله تعالى، ويجب على الداعي أن يتحلى بها، ويقوم بالدعوة إلى الله تعالى متَّصفًا بها؛ منها: التحلي بمكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، والصدق، والأمانة والحلم، وسعة الصدر والعفة، وعدم التطلع إلى ما آتى الله عبادَه من زينة الحياة الدنيا، والكرم، والتواضع، ولين الجانب، والشجاعة الحكيمة، وحُسن المعاشرَة للناس والرفق بهم، والتودد للناس صغارهم وكبارهم، فقرائهم وأغنيائهم، والتواضع وعدم الكبر، والتجرد من المصالح الشخصية، وعدم الانتصار للنفس.
ولا شك أنه لو اتصف الداعي بهذه الصفات، واجتنَب الفواحشَ وقول الزور؛ فإنه يؤثر في الناس أيما تأثير؛ يَأسِر قلوبهم، ويؤلفها ويَجمعها على الكلمة الطيبة والإيمان بالله وحده، ويستجيب الناس لدعوته، ويلتفون حوله كأنهم وجَدوا ضالتهم المنشودة.
ولكن للأسف الشديد! لقد فقدنا هذه الصفات وهذه الأخلاق، فيجب علينا أن نعود إليها ونصبح دعاة إلى الله تعالى؛ كما أمرَنا الله تعالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم.

[cov2019]