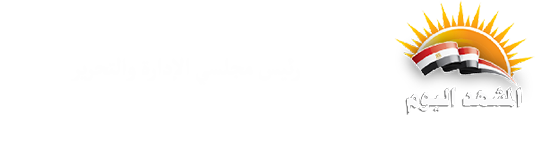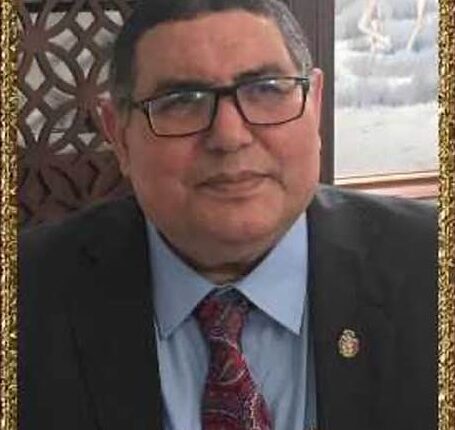دكتور خالد عبداللطيف ؛ يتحدث عن العقائد
بقلم \ المفكر العربى الدكتورخالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
مما لاشك فيه أن الفطرة قد بلغت مبلغًا كبيرًا من الفساد والانحراف قبل الإسلام، وضل الناس عن التوحيد ضلالاً بعيدًا، وسادت أمور الجاهلية في العقائد والسلوك، وقد مضى على بعثة آخر نبي مرسل – وهو عيسى عليه السلام – ما يزيد على خمسة قرون، وإذا نظرنا في العقائد السائدة قبل الإسلام، فسنجد عقائد وثنية كثيرة ومتنوعة؛ منها ما هو بشري وضعي، ومنها ما كان له أصل إلهي، ثم تعرض للتغيير والتحريف، فكان هناك من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ومن يعبد النار، ومن يقدس البقر، ومن يُؤلِّه أشخاصًا مخلوقين، ومن يعبد إلهين أو أكثر، ولإلقاء الضوء على تلك العقائد سأقتصر على بيان أربع منها، لبيان مدى الانحراف والفساد العقدي، وحاجة البشرية إلى إصلاح وتقويم، والعودة بالفطرة إلى حالتها الأولى:
1- البوذية: كانت سائدة في بلاد الهند وأوساط آسيا (الصين واليابان وكوريا حاليًّا)، وقد ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد، وقامت على عبادة (بوذا) واتباع تعاليمه؛ حيث جعله أتباعه إلهًا بعد مماته، وما كان يفكر في حياته، ولم يحلم أن يكون كذلك، ومن تعاليمه التقشف وقهر متطلبات الجسد على حساب الروح، والمحبة والتسامح وفعل الخير، أما مؤسس هذه النِّحْلة هو (سدهارتا جوتاما) الملقب بـ(بوذا)، ومعناه العالم المعتكف، أو العارف أو المستنير، وقد نشأ في بلدة على حدود نيبال، وكان أميرًا في أسرة ثرية، فشب مترفًا في النعيم، وتزوج في التاسعة عشرة من عمره، ولما بلغ السادسة والعشرين، وكان في ليلة حفل صاخبة، ترك الحفل فجأة وانصرف، وقد خلع زي الترف وارتدى زي الخشونة والتقشف، وبدأ رحلة التأمل في الكون، ورياضة النفس تحت شجرة! وبعد التأمل قرَّر أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات، كما قرر أن يتحمل خطايا البشر، ولهذا سماه أتباعه المخلص! وجعله البعض إنسانًا كاملاً وإلهًا كاملاً تجسَّد بالناسوت، وأنه قدم نفسه ذبيحة؛ ليكفر ذنوب البشر، ويخلصهم من ذنوبهم؛ كيلا يعاقبون عليها، (وهي الأسس التي اقتبسها “بولس” بعد ذلك وأدخلها في النصرانية)، وعلى هذا فإن البوذية لا تعترف بالله أصلاً ولا بوجوده!
2- اليهودية: أرسل الله موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل؛ ليخلصهم من بطش فرعون وظلمه واستعباده لهم، وليأمرهم بتوحيد الله عز وجل، وقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام أيضًا أن يذهب إلى فرعون وهامان وقارون؛ ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة المال والسلطة، والتخلي عن التجبر والتكبر في الأرض بغير الحق، والانتهاء عن ادعاء الألوهية أو الربوبية .. وقد أيد الله تعالى موسى بمعجزات باهرة قوية، بلغت في تأثيرها أن آمَن سَحَرَةُ فرعون لَمَّا جمعهم موسى وشاهدوا ما جاء به من آيات .. غير أن الطبيعة المادية لبني إسرائيل جعلتهم لا يقرون بفضل الله تعالى عليهم، ولم يشكروه ولم يُوحدوه؛ إذ إنه لَمَّا نجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده، وأغرقهم في البحر، ورأوا ذلك بأعينهم، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه؛ يقول الله عز وجل: ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: 138].
• قبائح اليهود وتجرُّؤهم على الله تعالى وعلى الملائكة وعلى الأنبياء، قد بلغت مبلغًا بعيدًا؛ فقد سبُّوا الله عز وجل، وسجَّل ذلك القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ [المائدة: 64]، وفي موضع آخر: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: 181]، وسجل القرآن أيضًا عداءهم للأنبياء وقتلهم لرسلهم، فقال: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 155].
ويدَّعي اليهود أنهم شعب الله المختار، وأن الجنة لهم وحدهم، وأن غيرهم من الأُميين (الجوييم) على باطل، وعاشوا قرونًا طويلة ينتظرون بعثة نبي منهم يقودهم إلي حكم العالم، وإقامة مملكة يهود، ولهذا لَما أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام تآمَروا على قتله، وحرَّضوا عليه الرومان الوثنيين، ثم بعَث الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون زمن بعثته ومكان رسالته، فلما جاء من العرب ومن نسل إسماعيل عليه السلام، كفروا به وتآمروا عليه كعادتهم؛ قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 89]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 101].
• لقد حرف اليهود التوراة، ووصفوا الله العلي الأعلى بما لا يليق به سبحانه، فقالوا – ولبئس ما قالوا -: إن عزيرًا ابن الله، تعالَى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، ولهذا فإن فسادهم وإفسادهم على مر العصور قد بلغ مبالغَ بعيدة؛ من إثارة الحروب والنزاعات، وتدمير الأخلاق وإفساد الفطرة، فهم قادةُ الدنيا في هذه الأمور، غير أن جريمتهم الكبرى أنهم طعنوا في الله تعالى ونقضوا التوحيد! وأفسدوا في الأرض، كما أنهم نكلوا عن الجهاد لَمَّا أمرهم موسى عليه السلام بقتال الجبارين (الكنعانيين الوثنيين)، وقالوا: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ﴾ [المائدة: 24]، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه في الأرض أربعين سنة.
3- النصرانية:
أ- دور بولس الرسول في النصرانية: فقد كان يهوديًّا يكره النصرانية، ثم ادعى المسيحية وأن عيسى عليه السلام أمره أن “يكرز”؛ أي: يُبشر بالنصرانية، وكان قد درس البوذية، ثم أدخلها في النصرانية، فأصبحت النصرانية خليطًا من الوثنيات القديمة؛ حيث أضيف إليها بعض عقائد وطقوس الديانة المصرية القديمة، ثم لما دخل الرومان المسيحية روَّموها ولم تتنصَّر الرومان؛ أي: أدخلوا فيها عقائدهم الوثنية، وكان ذلك بعد دخول قسطنطين زعيم الرومان إلى المسيحية، ولما قبلوه بوثنيته تكفل بعد ذلك بحمايتهم، وفي عهده تم إقرار البنوة (أن عيسى ابن الله)، والتثليث (الآب والابن والروح القدس)، وفي هذا يقول سبحانه وتعالى عنهم: ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة: 30]، ومعنى: (يضاهئون): من المضاهاة وهي المشابهة، فهم يتشبهون بالكافرين من قبلهم، وهم: المصريون القدماء والبوذيون واليهود والرومان؛ يقول صاحب تفسير (المنار) للشيخ محمد رشيد رضا: “وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول – (أي حلول الله تعالى في شخص إنسان) – والتثليث، كانت معروفة عند البراهمة (والبوذيين) في الهند والصين واليابان، وقدماء المصريين وقدماء الفرس (والرومان)، وهذه الحقيقة التاريخية قد بينها القرآن في هذه الآية، وهي من معجزاته؛ لأنه لم يكن يعرفها أحد من العرب ولا ممن حولهم………..)، وبهذا أفسد بولس (اليهودي) وقسطنطين (الروماني) النصرانية.
ب – تعدد الأناجيل واختلافها: سبق أن ذكرت أن الإنجيل الحقيقي لعيسى عليه السلام قد اختفى أو أُحرق بسبب عداء اليهود والرومان له عليه السلام، ولأتباعه من الحواريين الذين تفرقوا في البلدان هربًا من الظلم والاضطهاد، ولهذا ابتدع الكثير منهم الرهبانية، وهي ترك الجهاد وترك الدنيا ومتاعها، والانقطاع للعبادة، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: 27]، فكانت العقيدة على مدى ما يزيد على قرنين من الزمان هي عقيدة التوحيد، ثم لما دخلت الرومان بدأت الوثنيات تدب في عقيدة التوحيد وتفسدها، حتى كان مجمع نيقية عام 325م الذي كان من أهم قراراته: إبطال أقوال وعقائد الموحدين ممثلة في دعوة “أريوس” الموحد، ثم إقرار وإدخال عقائد أخرى؛ كالبنوة، وألوهية المسيح، والتثليث .. وقد أُلِّفت قبل وبعد مؤتمر أو مجمع نيقية أناجيلُ كثيرة.
ج – وقد جاء في دائرة المعارف البريطانية أنها بلغت خمسة وعشرين إنجيلاً، وقد ألغيت واندثرت ولم يعد لها أثر، ثم أقرت المجامع والكنائس بعد ذلك أربعة أناجيل، وهي المعتبرة عندهم، وهي: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا، ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى على هذا، فيقول: (هذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس، وتقرها الفرق المسيحية، وتأخذ بها، ولكن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل أخرى، قد أخذت بها فرق قديمة، وراجت عندها، ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها، ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناجيل “الصادقة”! – في اعتقادها – فاختارت هذه الأناجيل الأربعة “الرائجة”، وهذه الأناجيل لم يُملها المسيح، ولم تنزل عليه هو بوحي إلهي، ولكنها كُتبت من بعده…)؛ انظر: محاضرات في النصرانية؛ للإمام أبي زهرة، دار الفكر العربي ط3 ص37، 38.
انقطاع سند الأناجيل:
من خلال ما سبق يتبين بوضوح أن الأناجيل المؤلفة لا صلة لها بعيسى عليه السلام، ولا بالإنجيل المنزَّل عليه، كما أنه ليس أحد ممن ألفوا وكتبوا الأناجيل، قد رأى المسيح أو سمع منه، ولو حتى بواسطة راوٍ أو أكثر؛ (كما هو عندنا في الأحاديث؛ إذ لا بد من اتصال السند؛ وهي العنعنة من آخر راوٍ إلى متنهاه إلى الرسول صلى الله علية وسلم أو الصحابي..)، ويدعي كتبةُ الأناجيل أنهم كتبوها بالإلهام، ونحن لا ندري ما المقصود بالإلهام؟ وما هي دلائله؟ يقول الشيخ محمد أبو زهرة: (إن المسيحيين يقولون أن هذه الكتب كلها كُتبت بالإلهام، وأنها لذلك لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي حق وصدق؛ لأنها موحى بها؛ أي: بوحي..)، ونحن نسأل: هل يقصدون بالإلهام أنه الوحي؟ وعليه فهل كانوا رسلاً من عند الله؟ وما الدليل على ذلك؟ وما هي معجزاتهم؟ (لأن المعجزة تأييد من الله تعالى لرسوله حال دعواه ليصدقه الناس؛ لأنها أمر خارق للعادة)، ويذكر فضيلة الشيخ أبو زهرة كلام أحد مؤلفي “موجز تاريخ الأمة القبطية” في شأن الكتاب المقدس واسمه “هورن” ما يلي: (إذا قيل: إن الكتب المقدسة أُوحي بها من عند الله، فلا يراد أن كل الألفاظ والعبارات من إلهام الله، بل يعلم من اختلاف محاورات المصنفين، واختلاف بيانهم أنهم قد جوز لهم أن يكتبوا على حسب طباعهم وعاداتهم وفهومهم، واستعمل علم الإلهام على طريقة استعمال العلوم الرسمية..)، وعلى هذا فإن دعوى الإلهام لا نثق فيها، كما نقطع بأن الأناجيل الموضوعة لا صلة لها بعيسى عليه السلام، وحرصًا على الاختصار وعدم الاستفاضة، فإني أطرح سؤالاً:
لماذا حُرِّفت التوراة واستبدلها اليهود بالتلمود، وهو مقدس عندهم أكثر من التوراة، وفيه من الجرأة على الله ومن القبائح والافتراءات ما تقشعر منه الأبدان، وتَنفر منه الطباع السليمة؟! ولماذا اختفى الإنجيل الحقيقي واستُبدِل بأناجيل موضوعة مؤلفة؟!
الجواب في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، ويتضح من الآية الكريمة ومن قوله تعالى: ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا ﴾ – أن الله تعالى قد وكل حفظ التوراة والإنجيل للربانيين والأحبار، ولم يتكفل هو سبحانه بحفظهما، فماذا حدث؟! لقد حُرِّفت التوراة وبُدِّلت، ولم يعد للتوراة التي أُنزلت على موسى عليه السلام أثر يذكر ولا للإنجيل، والأدلة على ذلك كثيرة، أذكر منها قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: 79]، ومع تحريفهم للتوراة، فإنهم يظهرون بعضها ويخفون بعضها الآخر حسب أهوائهم ومصالحهم، وفي هذا يقول تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: 91]، فتبيَّن من هذا أنهم جعلوا كتابهم قراطيس؛ أي قطعًا وأوراقًا يظهرون منها ما يريدون، ويخفون ما لا يريدون، مع أنها مِن صنعهم وما كتَبت أيديهم!
1- أنه كتاب معجز، فلقد كانت معجزات السابقين مادية حسية، لا تؤثر إلا فيمن يراها ويحضرها، أما القرآن الكريم فهو يخاطب العقل والوجدان إلى يوم القيامة، وألوان إعجازه لا تنتهي إلى آخر الزمان، وليس المجال تفصيل ذلك، غير أن الله تعالى تحدى الخلق جميعًا أن يأتوا بمثله كما في سورة الإسراء: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: 88]، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور؛ كما في سورة هود: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود: 13]، ثم كان التحدي بأقل من ذلك؛ كما في سورة البقرة: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 23، 24] وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ دليل على أن التحدي ما زال قائمًا ومستمرًّا، ويدل أيضًا على عجز الخلق جميعًا أن يأتوا بآية أو سورة مثل ما في القرآن الكريم، وهو دليل الإعجاز!
2- إن بقاء القرآن كما هو من غير تحريف أو ضياع، وأنه يتلى كما نزل به جبريل عليه السلام، وكما تعلَّمه وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومَن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ولم ولن يتغيَّر منه حرف واحد – لهو دليل إعجازٍ.
3- وهو القول الفصل، وهو أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، فلم ينله التحريف أو التغيير، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، وضمن ذلك أيضًا في قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى: 6]، والمعنى: فلن تنسى، وقوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: 16 – 19]، وقد تحقق وعد الله تعالى بحفظه، فهو محفوظ في الصدور وفي السطور، ولقد يسر الله تعالى حفظه في الصدور، فيحفظه الصغير والكبير، العربي والأعجمي، كما أن له وقعًا في القلوب والنفوس، فمن تلاه أو قرأه، اطمأن قلبه وطابت نفسه، ونزلت عليه السكينة، وغشيته الرحمة!!
ومن هنا كان الاعتماد على القرآن الكريم في دراسة توحيد الألوهية، لكن قبل البدء في هذه الدراسة، أُجيب على هذا السؤال: لماذا أنزل الله تعالى القرآن على أمة العرب، (وهو الأمر الرابع بعد الحديث عن البوذية واليهودية والمسيحية)؟!
الجواب: هناك أسباب تخص العرب أنفسهم، وأسباب لا صلة لهم بها، أما ما يخص العرب، فهم كانوا أهل الفصاحة والبلاغة، وقد وصلوا إلى أرقى ما يصل إليه الفكر البشري والنشاط الأدبي، فقد كانوا يقيمون الأسواق واللقاءات الفكرية، وينشدون الأشعار، ويتبارون في ذلك ويتسابقون، ويختارون أفضل القصائد؛ ليَعلقوها في الكعبة، وهي ما أُطلق عليها (المعلَّقات)، كما أن قريشًا على وجه الخصوص – ومنها النبي المختار – كانوا يتميزون بأرقى اللهجات، لهذا لما نزل القرآن وسمعوه تحيروا، فقد شد انتباههم فلم يعارضوه، واعترفوا بحسنه وبهائه، وأنه ليس شعرًا ولا كهانة، كذلك فإن العرب كانوا يتميزون عن غيرهم بنقاء الصفات، فمن كان منهم كافرًا، فهو كافر بصدق، ويعلن ذلك صراحة، بل يدافع عن كفره، ومن كان منهم مسلمًا، فهو مسلم بصدق، ويضحي من أجل عقيدته … هذا وقد تميز العرب عن غيرهم باعترافهم وإقرارهم بربوبية الله عز وجل، ولَمَّا عبدوا الأصنام، لم يعبدوها على أنها خالقة أو رزَّاقة أو مُدبرة، بل على أنها مصنوعة منحوتة، لكن ظنهم الفاسد أن هذه الأصنام ستُقربهم إلى الله عز وجل؛ قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: 9]، وفي سورة الزمر: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: 3].
تأتي أهمية التوحيد؛ لأنه من أجله خلق الله العالمين، وأرسل رسله وأنزل كتبه، وللأسباب الآتية:
1- لأنه ضد الشرك، والله تعالى لا يغفره، كما أنه محبط للعمل؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48].
ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65].
2- ولأن التوحيد هو الدين، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا ليأمر الناس بعبادة الله؛ أي بتوحيده، وما من دين أنزله الله تعالى إلا وأساسه التوحيد، وهو أن يكون الحكم لله والعبادة لله؛ أي: أن تكون العبادة في الخضوع لحكم الله، وهذا هو الدين القيم المراد قيامه؛ قال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 40].
3- ولأن التوحيد هو الطريق إلى تحقيق الاستخلاف والتمكين في الأرض؛ قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: 55]، فكان تحقيق التوحيد ونفي ضده – وهو الشرك – الطريق الأكيد للتمكين في الأرض.
4- لأنه تحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل؛ سواء كان هذا المعبود (بالباطل) شيطانًا أو شجرًا، أو حجرًا أو بشرًا نصب نفسه إلهًا يشرع للناس، أو نصبه الناس في حياته أو بعد مماته، فهو طاغوت قد تجاوز حدود بشريته، فيجب التحرر منه والكفر به؛ لأن الله تعالى هو المعبود الأوحد؛ لأنه هو الخالق الأوحد المتفضل بالنعم كلها؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [البقرة: 256]، وفي تفسير ابن كثير: (العروة الوثقى): يعني: لا إله إلا الله.
5- لأن التوحيد يدفع أهله إلى التضحية والموت بحب وشوق إلى لقاء الله الذي يحبهم ويحبونه، ويحاربون أدعياء الألوهية وأتباعهم وأعوانهم؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76]، قال ربعي ابن عامر رضى الله عنه لرستم قائد الفرس لَمَّا سأله عن سبب مجيئهم: “إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام….”.
6- لأن التوحيد هو أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لقومه، وهذا يحتاج إلى بيان، وأوضحه فيما يلي:
أ- لقد كان العرب يقرون بالرب الخالق، لكنهم يرفضون الرب الإله الحاكم المشرع، ومع اعترافهم بالرب الخالق، فقد كانوا يعبدون أصنامًا صنعوها بأيديهم، فكانت الحكمة في بدء مخاطبتهم بالربوبية التي يقرون بها، وذلك لتجنب الصدام معهم منذ اللحظة الأولى، ومن هنا كان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: 1، 2]، وهذا الخطاب لا سبيل لهم إلى إنكاره، ولعل هذا هو السر في هذه البداية الحكيمة، ولقد كان القرآن المكي يتنزل لتصحيح التصورات عن الرب الخالق، فهو سبحانه ليس بحاجة إلى واسطة ولا أصنام تُقرِّب إليه، وهو سبحانه يسمع صوت الضعيف العاجز، ويسمع الهمسات، بل يطلع على خفايا النفوس وخبايا الصدور، وإذا قال العبد: يا رب بصوت خافت، أو حرَّك بذلك لسانه، قال له الرب سبحانه: “لبيك عبدي”، وهو سبحانه لا شريك له في ملكه، وليس في حاجة إلى مساعد أو مستشار، وليس في حاجة إلى ولد أو زوجة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وهو سبحانه كما خلق الخلق من العدم، سيعيدهم مرة أخرى ليحاسبهم ويجازيهم، وهو سبحانه لا يعجزه شيء ولا يتعب من عمل شيء، وهو سبحانه لا ينام ولا تأخذه سِنة، وهو حي قيوم قائم بنفسه، والكل – غيره – قائم به محتاج إليه، متفضل على خلقه بالنعم من غير سؤال، وإذا سُئل أعطى، وعطاؤه بغير حساب، من أساء معه الأدب وعصاه، وفَّاه حقه في الدنيا وأمهَله، ثم جازاه، ومَن آمن به وأقرَّ له بالوحدانية، ابتلاه ليُمحصه ويَمتحن دينه وتقواه، يقبل توبة مَن كفر به وعصاه!
ب- كان هذا هو محتوى الخطاب المكي.
ج – كان الحديث عن الربوبية وتصحيح التصورات عن الرب الخالق، هو المدخل وهو التمهيد لتوحيد الإلهية؛ أي: بما أنه الرب الخالق الرزاق المتصرف المحيي المميت السميع البصير، إذًا فهو الإله المعبود الآمر المطاع، فلا يجوز تصريف أنواع العبادة إلا له وحده؛ لأنه لا شريك له في الخلق، فلا شريك له في الأمر؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54]، وتأمل هذا المعنى، وهو (في الخلق): تبارك الله رب العالمين، و(في الأمر): تبارك الله رب العالمين؛ أي: إنه سبحانه بقدرته وعزته وعظمته وحكمته، كما أحسن كل شيء خلقه، فقد أحسن كل شيء شرعه، فخلقه أحسن الخلق وأكمله، وشرعه أكمل الشرع، وحكمه أكمل الحكم، ومن هنا كان قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]، هذا وشرعه وحكمه قد فصله في القرآن الكريم، فكيف وهو الرب الخالق المالك المتصرف الرزاق، المحيي المميت- أن يكون غيره حكمًا ومشرعًا؟ قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [الأنعام: 114].
د – لتحقيق توحيد الألوهية، كان القرآن المكي معنيًّا بالتمهيد لقبول الأحكام والتشريعات، فلم ينزل في مكة تشريعات، وإنما بدأت التشريعات في المدينة المنورة، وكانت حسب سنة التدريج)، وكان التمهيد لذلك يسير في خطين متوازيين؛ الأول: تأكيد أن الأحق بالطاعة والانقياد هو الله وحده، وأنه سبحانه الأحق بالتشريع، فلا حكم إلا له، ولا تحاكم إلا إليه، وأن إقامة الدين عقيدة وشريعة، هو توحيد الألوهية التي يجب على كل موحد بالله أن يُحقق هذا الأمر في نفسه وفي الكون من حوله!
الخط الثاني: الترغيب في الخيرات واجتباب المنكرات؛ كالترغيب في الإنفاق والإحسان إلى المخلوقين، وحفظ الفروج والأمانات، وغير ذلك، مع الترهيب من المنكرات والأمر باجتنابها؛ كقول الزور، والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وغير ذلك.

[cov2019]