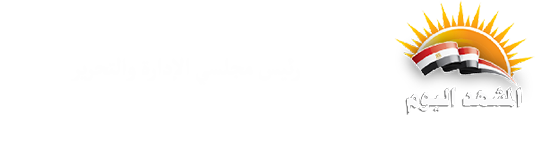رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن الإفتاء منصب كبير وعمل خطير
ويدل على ذلك حديث النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»(13).فأنت ترى أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قَسَّم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، فَعُلِم أن الحق عند الله واحد غير متعدد.كما أن الفقهاء لم يزل بعضهم يردُّ على بعض، ويُخَطِّئُ بعضهم بعضاً.
قال ابن عبد البر – رحمه الله – : «والصواب مما اختلف فيه وتدافع: وجهٌ واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خَطّأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء ضده صواباً كله»(14).